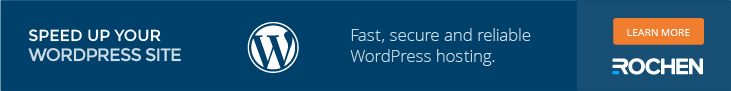الإنسان كما الحياة، أحواله فى صيرورة دائمة لا تتوقف.. يتغير كل منا فى حياته.. مع جيله وسنه مرات ومرات.. خاصة إن طال عمره.. وهذا مطرد دائم فى أجيال آبائنا القريبين، وفى أجيال آبائنا البعيدين.. وأجيال البعيدين البعيدين جداً.. الذين لا نعرف حتى أسماءهم، وقلَّما نهتم بمحاولة معرفتها!
وهذا التغير المتوالى المستمر.. لا يشعر به كل منا على هذا النحو إلاّ متأخراً بعد حصوله.. ريثما ينسى واقع ما كان، ويبقى فى ذاكرته ما يبقى منه مع حاضره.. وكل منا كلما تقدم فى السن يظن أنه عرف من قبل ما لا يعرفه المراهق والشاب والرجل!.. هذا لأن كلاً من هؤلاء يعيش جيله ولا يعيش جيل غيره.. ولكن عملية التثبيت والحفظ والارتقاء والتحضر أو التخلف والركود والتأخر لازمة هى الأخرى لبقاء البشرية بحسب ظروفها، ولازمة لربط ما عرف فى الماضى بما عرف فى الحاضر بكل صور الروابط المؤكدة أو الموضحة أو المكملة أو المعدلة أو المتغيرة أو المتجمدة!
فالتغير الدائم فى كل فرد، إنما يصاحبه دائماً ضرب من التثبيت مطرد فى الجماعة التى يعيش فيها.. يشعر به الفرد ويستجيب له فى الغالب. وهذا الضرب من التثبيت، هو الذى يعطى أفراد كل جماعة خصالهم على اختلاف طبقاتهم وصلاتهم المتشابهة.. كباراً أو صغاراً.
ويحسب كل منا أنه هو أهم من فى الوجود من البشر، فإن تواضع وتطامن اكتفى بأنه كذلك على الأقل فى نظر نفسه.. لكنه برغم ذلك يحاول ما استطاع أن يقنع غيره بأهميته.. وقد ينجح فى تحقيق مراده لسبب أو لآخر، وغالباً ما لا ينجح!.. وهذا من أسس الجماعات البشرية التى لم تنجح فعلاً وحقاً فى الشعور بالمساواة الصادقة بين جميع أفرادها كباراً وصغاراً.. ولم تنجح أى جماعة حتى الآن فى إزالة الطبقات فيها إزالة حقيقية.. وإدراك هذا النجاح لا يدين فى أى زمن إلا إذا استطاعت الجماعة، باتساع المتاح سعة هائلة، ربما بارتياد الفضاء الواسع، أن تحقق بحبوحة فى كل مجال تغطى حاجات الناس وزيادة، وتيسر بسهولة ويُسر لكل آدمى عادى الانتفاع بما يريده، والاستفادة الكاملة مما يوجد فى الفضاء الواسع من قدرات وقوى ومواد باتت الآن أقرب إلى أيدينا مما كنا نتصور إلى عهد قريب!
فقد أمكن لسفن الفضاء البشرية الصنع أن تجوب الفضاء لأبعد كواكب المجموعة الشمسية، وترتاد المشترى وزحل وأورانوس وأخيراً نبتون.. بأسماء بشرية اصطلح عليها علم الفلك عندنا.. وهو ما لم يحدث من قبل خلال الثلاثة آلاف سنة الماضية.. قد عرفنا من عشرات السنين ما سميناه بالسنة الضوئية التى تبلغ سرعة الضوء فيها 300 ألف كيلومتر فى الثانية الواحدة.. يقطع ضوء الشمس المسافة منها إلينا خلال ثمانى دقائق يقطع فيها خمسة عشر مليون كيلومتر.. ويصل ضوء الشمس إلى أبعد كواكبها خلال خمس ساعات فى مساحة جاوزت خمسة آلاف مليون كيلومتر.. وبتنا نعلم يقيناً اليوم أن أرضنا تدور حول محورها بسرعة ألف كيلومتر فى الساعة، وتدور حول الشمس مع الشمس فى دورانها حول المجرة بسرعة ثمانية ملايين كيلومتر فى الساعة بحسابنا نحن. ودورانها الكامل حول المجرة مرة واحدة خلال ثلاثين مليون عام من أعوامنا بسرعة 220 كيلومتراً فى الثانية الواحدة.. لأن أقرب مجرة إلينا نحن أهل الأرض تقع على بعد مسافة مليون سنة ضوئية.. فضوء المجرة الذى يصلنا الآن قد انطلق من مليون سنة ضوئية، يعلم الله وحده هل هى باقية الآن أم أنها قد اختفت.. والعجيب المعجب فى ذلك هو قدرة الآدمى على الاهتداء وهو على أرضه إلى هذه الأكوان الهائلة فى الأبعاد النائية على الأزمان الغابرة التى تصل إلينا الآن فقط!
هذا الذى وصلت إليه البشرية لم يكن ثمرة آحاد فقط.. وإنما ناتج عطاء تجمعات آدميين هنا وهناك.. وهم الآن بالألوف فى معظم بقاع الأرض.. يخلف ميتهم حيُّهم ليصحح ما يستطيع تصحيحه، ويرى ما لم يتيسر له السبيل إلى رؤيته لغيره ممن سبقوه.. سواء لعدم الفرصة، أو لنقص الأداة، أو لهما معاً! هذا كله يعنى أن الفهم والعقل والمثابرة والإلحاح فى البحث والتقليب والتجريب لا تحتاج معاً لا إلى طول العمر ولا سعة الحجم ولا بعد المسافة ولا شدة السرعة بالغة ما بلغت ولا خفاء القوى التى لم يلحظها من قبل سابق.. جاذبة كانت أو طاردة.. مضيئة أو غير مضيئة.. متمددة أو قابضة!
فالآدمى على ما عرف فيه من خبث وجشع وشيطانية فيه أيضاً شىء ربانى يأخذ به وبيده وفهمه إذا التفت إليه.. يأخذ به إلى أعلى وإلى أوضح وإلى أعمق وإلى أبعد وأعجب مما اعتاد عليه.. وهو إلى اليوم دائم الترنح على ما فيه من تلك الشيطانية المعتادة التى تجره إلى الانحطاط.. يترنح بين كثرة الجهل وقلة العارفين، وبين الاندفاع فى الأطماع وقلة الأمناء الصادقين المتواضعين، وبين كثرة أهل الشر وندرة البررة الخيرين!.. فهل يمكن أن تنعكس هذه الحال قبل أن يلتهم الدمار الشامل حاضر البشرية كلها بكثرة أشرارها وقلة خيارها؟!
نحن إلى الآن فى مجموعنا أينما نكون.. لا نكف عن تبديد قوانا العقلية والبدنية فى خدمة العواطف والغرائز.. قليل القليل منا من يقتصد فى استخدام عقله وصحته ويتنبه لعدم تفريغها وإضاعتها فى خدمة عواطفه وغرائزه!.. لا نبالى بما نضيعه ونبدده من الأوقات والفرص القيمة وما نهدره ونفرط فيه من الجهود والأموال والعلاقات الطيبة.. وأيضاً من الأعمار التى يعرف كل منا أنها حتماً إلى نهاية!.. اعتدنا حتى الآن على تبذير الحياة والمغامرة بها، وعلى تفضيل الشهوة برغم مكابدتنا لأضرارها وخسائرها بدنية أو مالية أو عقلية.. كأنَّ الحياة فى كل منا لا أول لها ولا آخر.. وكأنَّ كلاً منا هو الصانع لحياته بدناً وروحاً وعقلاً!!.
ونحن فى هذه الدنيا وقتيون فقط.. سواء فى المجىء والحضور إلى الدنيا، أو فى الغياب والزوال منها.. ولكن شعورنا الحاد بـ«الأنا» يعطى لكل منا وهماً أنه هو كل شىء فى دنياه أولاً وآخراً.. لا فرق بين حاكم ومحكوم وغنى وفقير ومالك ومأجور.. هذه «الأنا» الفردية هى نقطة البداية والنهاية فى حياته!.. ولهذا لا يتساوى الآدميون فى «أنا» كل منهم قط!.. مهما اجتهد الآدمى فى الحرص على التساوى فى هذه الدنيا، فالأنا هى راية تفرد كل آدمى ووحدته التى لا يشاركه فيها والد أو ولد.. إذ القرابات تنطلق بداهة من حيث الأنا.. بيد أن لكل فرد مهما بلغت قرابته «أناه» الخاصة فى المصطلح الاجتماعى.. الآدمى أصلاً وفصلاً حىّ اجتماعى، وإنما فى حاجة لكى يبقى إلى آخر أو آخرين تحقيقاً لهذه الغاية أو تلك من ضروراته أو من لوازم حياته هو بالذات.. معتكفاً كان أو ناسكاً أو كاهناً، متجرداً أو راهباً أو ناذراً الخلوة الأبدية، أو كارهاً الخلق يباعدهم ويتحاشاهم.. فمهما تكن شدة هذه العزلة أو ذلك الاعتزال والانفراد، فلم يخلْ قط من اللغة التى تعلمها صاحبها من قبل، ولا من الأخذ والعطاء فيما يحتاجه من القوت والمأوى والكساء ولم يزدد فى العدد والعدة بل لعله قد قلّ!